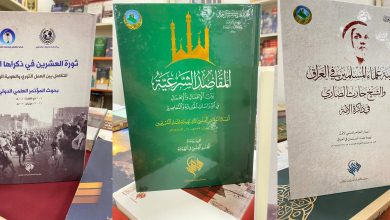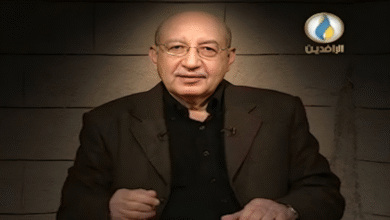الحكومات في العراق دمرت النظام الصحي بتقليص التمويل وإهمال البنية التحتية للمستشفيات
قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق: يعاني القطاع الصحي من مشاكل متفاقمة عديدة تشمل الفساد الإداري والمالي، ونقص التمويل، وتهالك البنية التحتية، واستمرار الهجرة الجماعية للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية.
تناول المحور الثامن من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق 2024، الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق الوضع الصحي والبيئي.
وعالج التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق – 2024 تحت عنوان “واحد وعشرون عامًا من الموت والخراب والفساد وتفكيك البلاد” أبرز قضايا حقوق الإنسان في العراق التي تم التعامل معها على مدار العام 2024، ويبين الأهداف التي أُعد لأجلها، والوسائل المتبعة لتحقيقها، وفق رؤية القسم والرسالة التي يحملها على عاتقه.
وتطلب إعداد هذا التقرير تحليلًا دقيقًا للأدلة والمعلومات، مع الالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية الدولية في إخراجها إخراجًا دقيقًا وحياديًا، بهدف تقديم تقرير موضوعي، قائم على الحقائق، ويسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة.
وتنشر قناة “الرافدين” المحور الثامن كجزء من نشر التقرير كاملا على أجزاء.
الوضع الصحي والبيئي
شهد القطاع الصحي في العراق، الذي يعد من الركائز الأساسية لصحة المواطنين وجودة حياتهم، تدهورًا مستمرًا نتيجة السياسات التي تبنتها الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال. وبدلاً من أن توفر للمواطنين الرعاية الصحية اللازمة والخدمات الطبية المناسبة، عملت هذه السياسات على تدمير النظام الصحي من خلال تقليص التمويل، وإهمال البنية التحتية للمستشفيات والمرافق الصحية، وتجاهل الاحتياجات الحيوية لهذا القطاع، نتج عن ذلك نقص حاد في المعدات الطبية الأساسية، فضلاً عن تفاقم نقص الكوادر الصحية المؤهلة بسبب الاستهداف المستمر في ظل الظروف الأمنية المتردية والإهمال الحكومي. هذا التدهور المستمر كان له تأثير مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وظل النظام الصحي في العراق بعد الاحتلال يعاني من انهيار ممنهج نتيجة السياسات الفاشلة لجميع الحكومات المتعاقبة التي لم تُعطِ الأولوية لاحتياجات المواطن العراقي.
وتركّز خطة هذا التقرير على القضايا الحقوقية من منظور محايد وموضوعي، مع عرض الأدلة والشهادات التي تدعم التحليل الوارد، بهدف تقديم تقييم شامل لأوضاع القطاع الصحي في العراق من منظور حقوق الإنسان، عبر الأسلوب المتبع في جمع البيانات مثل: المقابلات، والمراجعات الوثائقية، وإحصائيات المؤسسات الصحية والحقوقية المحلية والدولية المعنية بالشأن العراقي.
ويُعد حق الإنسان في الصحة من الحقوق الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع ذلك، فإن الحكومات المتعاقبة في العراق قد فشلت بشكل واضح في توفير هذا الحق للمواطنين. وعلى الرغم من أن تحسين الصحة العامة يعتبر محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الحكومات استمرت في الإهمال واللامبالاة، مما أسفر عن معدلات عالية من الأمراض ونقص في الإنتاجية، إلى جانب تدهور نوعية الحياة للمواطنين. هذه السياسات تعكس عدم الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه حقوق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية العادلة والميسرة.

إن توفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة يعد من العوامل الأساسية التي تسهم في الحد من الفقر، حيث أن غياب التأمين الصحي الكافي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العلاج ويشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، خصوصًا في ظل سياسات الحكومة التي فشلت في تأمين هذا الحق الأساسي. علاوة على ذلك، فإن مقتضى العدالة الاجتماعية يتطلب توفير خدمات صحية مجانية أو بتكلفة منخفضة للجميع، وهو أمر عجزت عن تحقيقه جميع الحكومات المتعاقبة بعد 2003، مما يساهم في زيادة الفجوات الاجتماعية ويعزز التفاوت في الوصول إلى الرعاية الصحية.
أما استقرار المجتمع، فيحتاج إلى نظام صحي فعال يضمن الرعاية للفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. لكن في ظل تدهور القطاع الصحي الناتج عن الإهمال الحكومي، فإن هذه الفئات لا تجد ما يكفي من الدعم والرعاية.
الواقع الصحي في العراق عجز حكومي مزمن وانهيار وشيك
في العراق، وعلى الرغم من الحديث عن التنمية المستدامة، تبقى الحكومة عاجزة عن تحسين القطاع الصحي. فبدلاً من زيادة الاستثمار في البنية التحتية وتدريب الكوادر الطبية، استمرت السياسات الحكومية في تجاهل هذه الأولويات الحيوية، ما أدى إلى المزيد من تفاقم الأوضاع الصحية وحرمان المواطنين من حقهم في الرعاية الصحية الجيدة، بغض النظر عن ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وينعكس الواقع السياسي والأمني والمالي الذي يعيشه العراق بعد 2003 سلبًا على الوضع الصحي، فالحكومات المتعاقبة لم تسعَ لمواكبة الاحتياجات الصحية للمواطنين بالتزامن مع الزيادة الحاصلة في عدد السكان، وهذا ما يؤكده تقرير البنك الدولي بشأن العراق، الذي أشار فيه إلى انخفاض عدد الأسرة في المستشفيات للفرد بشكل فعلي إلى النصف تقريبا خلال السنين العشرين الماضية. فبعد أن كان لكل ألف مواطن سريران تراجعت هذه النسبة في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة لتصبح سريرا واحدا لكل ألف مواطن، بالتزامن مع النقص الحاد في الأطباء الذي بلغ 75 طبيبا لكل مائة ألف مواطن.
وشهد العراق بعد الاحتلال، ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الإصابة بالسرطان بأنواعه المتعددة في أوساط فئات عمرية مختلفة، إلى جانب تفاقم حالات التشوهات الخلقية لدى المواليد الجدد، ولاسيما في محافظتي نينوى والأنبار ومحافظات وسط وجنوبي العراق، مع وجود أكثر من تسعين منطقة ملوثة بإشعاعات اليورانيوم المنضب والمخلفات الحربية، التي بلغت في الموصل وحدها 13 مليون طن، والتي تنشر الأمراض وتفتك بسكان تلك المناطق.
ارتفاع مستمر في معدلات الإصابة بالسرطان
وتعاني محافظة البصرة من مشاكل بيئة كثيرة وانتشار الأمراض السرطانية والأوبئة بشكل كبير بسبب التلوث والإشعاعات، 1.3 مليار متر مربع ملوثة بالإشعاعات الحربية والألغام التي تسببت انفجاراتها بسقوط عشرات الضحايا خلال 2024 معظمهم نساء وأطفال، والتي لم تعمل الجهات المعنية على تطهيرها وإنهاء آثارها الفتاكة على أهالي تلك المناطق خاصة وسكان العراق عامة، إلى جانب عدم معالجة الأسباب الأخرى ولاسيما المتعلقة بعمليات استخراج النفط وانتشار مطامر النفايات العشوائية وارتفاع مستوى التلوث البيئي في عموم العراق الذي بات ضمن الدول الأكثر تلوثًا في العالم.
وفي محافظة الأنبار كشف تقرير استقصائي عن ارتفاع كبير في نسب الإصابة بمرض السرطان في المحافظة نتيجة استخدام الأسلحة المحظورة في الحروب المتكررة التي شهدتها المحافظة بعد الاحتلال، إضافة إلى التلوث البيئي الكبير الذي تعاني منه المحافظة.
وصرح عدد من المرضى بأن هناك نقص حاد في الأدوية والعلاجات ومنها جهاز للإشعاع وأن نقص الأدوية أجبر بعضهم على شرائها من السوق بأسعار باهظة لا يقوى الكثير منهم على تحملها.
وفي محافظة نينوى، تعرضت مدينة الموصل، لتدمير شبه كامل لمرافقها الصحية خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” بين عامي 2016 و2017. وتُظهر التقارير أن 18 مستشفى في نينوى دُمرت بالكامل، مما أدى إلى انخفاض عدد الأسرة الطبية من 6000 سرير قبل عام 2014 إلى نحو 1700 سرير بعد الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تعرض 76 مركزًا صحيًا للتدمير الكلي أو الجزئي من أصل 98 في عموم المدينة.
في محاولة لتوفير الخدمات الصحية، تم إنشاء مستشفيات ومراكز صحية مؤقتة مصنوعة من مواد غير دائمة، تُعرف بـ”المستشفيات الكرفانية”. وهذه المنشآت كانت تهدف إلى سد الفجوة في تقديم الرعاية الصحية لحين إعادة بناء المستشفيات الدائمة. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه المنشآت غير كافية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، خاصة مع تزايد عدد المرضى وتنوع الحالات الطبية.
في مارس 2024، أصدرت وزارة الصحة الحالية تعليمات بإغلاق جميع المستشفيات والمراكز الصحية “الكرفانية” في نينوى، دون توفير بدائل دائمة.
أثار هذا القرار قلق الأطباء والمواطنين، حيث حذروا من تأثيره السلبي على تقديم الخدمات الصحية في المحافظة. على سبيل المثال، مستشفى الجمهوري في الموصل، الذي استقبل في عام 2023 أكثر من مليون مراجع وأجرى 32 ألف عملية جراحية، كان من المقرر إغلاقه، مما يهدد بتفاقم الوضع الصحي المتدهور.

تواجه نينوى تحديات كبيرة في إعادة بناء قطاعها الصحي، حيث تحتاج إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة. تتطلب هذه العملية تضافر جهود الحكومة المركزية والمحلية والمنظمات الدولية لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للسكان.
في الوقت الحالي، لا تزال المستشفيات الكرفانية تشكل جزءًا أساسيًا من النظام الصحي في نينوى، مما يبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول دائمة وفعّالة لتحسين الوضع الصحي في المحافظة.
وعلى الصعيد نفسه، تعاني مستشفى الديوانية العام، وهو المستشفى الرئيسي في المدينة، من نقص حاد في التجهيزات الطبية نتيجة للإهمال والفساد المستشري في القطاع الصحي. وقد أظهرت تقارير سابقة أن المستشفى يعاني من نقص في المعدات الطبية الأساسية، مما يؤثر سلبًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. على سبيل المثال، وفي التقارير التي نشرت في عام 2024، تمت الإشارة إلى نقص المعدات والخدمات الطبية في المستشفيات العراقية كافة، بما في ذلك مستشفى الديوانية العام
في الآونة الأخيرة، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمواطنين من مدينة الديوانية وهم يناشدون الجهات المعنية لتوفير الدعم والمساعدة للأطفال المرضى في المستشفى. وقد حمّل المواطنون السلطات المعنية المسؤولية عن الوضع المتدهور في المستشفى، مطالبين بتوفير التجهيزات الطبية اللازمة وتحسين الخدمات الصحية.
الإهمال الطبي يؤدي إلى الموت والعوق
كشف مواطنون من سكان محافظات مختلفة في العراق عن تعرض أطفالهم للعوق وبتر الأعضاء والموت في بعض الحالات بسبب نقص الأوكسجين والأدوية اللازمة للعلاج والإهمال الطبي، وفي هذا الإطار، يعزو مسؤولون في وزارة الصحة أسباب ما وصل إليه النظام الصحي في العراق، إلى أن هناك غيابا مزمنا لاختيار الشخص المناسب، إذ إن التعيينات في القيادات العليا في وزارة الصحة تتم وفق المحاصصة وتتأثر كثيرا في نظام التناوب الحزبي على الوزارة، وتدخل فيها صلة القرابة وغيرها من أوجه الفساد. كما نرى الكثير من المديرين في دوائر الصحة من حصة هذا الحزب أو أحد أقرباء ذلك المسؤول، بحسب تعبيرهم.
سوء الإدارة يفضي إلى الانهيار
بحسب خبراء الاقتصاد فإن مشكلة الواقع الصحي في العراق شبه المنهار تكمن في إدارة هذا الملف، سواء إدارة الأموال أو الإدارة البشرية، وإن الفساد السياسي يسيطر على القرار المهني في القطاع الصحي، كما إن ظاهرة الموظفين الوهميين منتشرة في هذا القطاع، حيث يتقاضون الرواتب من دون ممارسة أي عمل، وهناك فئات اغتنت من هذا الفساد. ويؤكد الخبراء أن إصلاح القطاع الصحي يحتاج إلى إبعاده عن نظام المحاصصة، وتفعيل قانون التأمين الصحي وربطه بقانون العمل، أي أن يصبح أي موظف مشتركا في التأمين الصحي، وهذا سيعزز آلية تحسين هذا القطاع المهمش.
وسجل العراق خلال العقدين الماضيين ارتفاعًا ملحوظًا ومرعبًا في معدلات تجارة وتعاطي المخدرات التي تدخل 80% منها عن طريق “الجارة” إيران، من جراء تفاقم العوامل المحفزة والمشجعة لتنامي ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع، وزادت أعداد متعاطي المخدرات في جميع أنحاء البلاد بنسب وصلت إلى مؤشرات شديد الخطورة، وقد أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن نسبة الإدمان على المخدرات في أوساط الشباب تجاوزت 50%، في حين تصل نسبة التعاطي إلى 70% في المناطق والأحياء الفقيرة.
80% من المخدِّرات قادمة من إيران
ويؤكد معظم العاملين في مجال الصحة في العراق أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير لأن العديد من الأطباء المحليين يفتقرون إلى المعرفة المتخصصة لتشخيص حالات إدمان المخدرات بسبب افتقار البلد لمختبرات كافية متخصصة بعلم السموم، يمكنها مواكبة الأنواع المختلفة من المخدرات التي تدخل إلى البلاد، وإن العديد من الحالات التي شاهدها الأطباء هي حالات متعاطي المخدرات ومدمنين على الكحول أيضًا. وبهذا الشأن أشار أطباء في مستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في بغداد إلى زيادة مقلقة في استخدام العقاقير مثل الكوكايين والماريجوانا والفاليوم والأمفيتامينات. مؤكدين أن المصدر الرئيسي للمخدرات مثل الكوكايين والماريجوانا والكريستال ميث هو إيران. وهذا يحصل بالتزامن مع انتشار ظاهرة الصيدليات غير المجازة وبيع الأدوية الفاسدة في ظل انعدام الرقابة بشكل مزمن وانتشار أدوية منتهية الصلاحية المهربة من إيران في بغداد مع ارتفاعات متكررة بأسعار الأدوية والمواد الأساسية الأخرى من جراء ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي أثر سلباً على أمن المواطن الغذائي والصحي.
الحكومات متورطة بتجارة المخدرات
أصبحت قضية تجارة المخدرات في العراق ما بعد الغزو الأمريكي من القضايا الشائعة التي تثير العديد من التساؤلات حول دور الحكومة في مكافحتها والتصدي لها. في السنوات العشر الأخيرة، أصبح العراق أحد ممرات تهريب المخدرات الرئيسية في المنطقة، مما أثار قلقًا متزايدًا بشأن تورط جهات داخل الحكومة أو الأجهزة الأمنية في هذه الأنشطة غير القانونية. ومن بين المؤشرات التي تدلل ذلك:
1- زيادة مرعبة في انتشار المخدرات في العراق، حيث يشهد البلد في الوقت الحالي تزايدًا مرعبا في انتشار المخدرات بأنواعها المختلفة مثل “الكريستال” (الميثامفيتامين)، والحشيش، والأفيون، وغيرها من المواد المخدرة. ويتزايد استهلاك المخدرات بين الشباب العراقيين، إذ تصل نسبة إدمان المخدرات بين الشباب إلى 50%، مما يعكس تراجعًا في أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وأعلنت الحكومة في مرات عديدة عن محاولات لتصحيح الوضع والحد من هذه المشكلة، لكن النتائج كانت محدودة جدًا نظرًا للأسباب المعقدة المتعلقة بالنزاعات المستمرة، والضعف الممنهج للأجهزة الأمنية، وغياب الرقابة الفعالة على الحدود.

2 – تورط بعض الأفراد في تجارة المخدرات، وهناك تقارير إعلامية ودعوات من منظمات حقوق الإنسان تشير إلى تورط بعض المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن وبعض الجهات السياسية، في تسهيل عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود. وبحسب التقارير، هناك جهات من داخل الحكومة أو الميليشيات المسلحة يستغلون مواقعهم ونفوذهم لتسهيل دخول المخدرات إلى البلاد أو لتأمين مسارات تهريب عبر المناطق الحدودية مع إيران وسوريا.
وهذا التورط الحكومي في تجارة المخدرات يعكس مشكلة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، حيث أن الميليشيات والقوات الأمنية تستفيد من تجارة المخدرات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
3 – التهريب عبر الحدود، العراق يعد نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدرات من إيران وسوريا. وبات العراق في ظل حكومات الاحتلال مسارا رئيسيا لتهريب المخدرات إلى دول الخليج العربي، وأوروبا. وتغيب الرقابة الحكومية بشكل ممنهج للحدود، بحجة أنها واسعة وأن وعورة التضاريس تصعب مراقبة هذه العمليات والحد منها، ما يسهل أنشطة التهريب التي يستفيد منها العديد من الجهات داخل وخارج الحكومة.
4 – التقصير الحكومي الواضح في مكافحة تجارة المخدرات، وتتهم العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الحكومة في العراق بأنها فشلت في معالجة قضية المخدرات بشكل جاد، بسبب الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة، والضعف المزمن للقدرات الأمنية.
كما أن العراق يواجه نقصًا متعمدا في البنية التحتية للمراقبة والحد من هذه التجارة، حيث يفتقر إلى نظم الرقابة على المعابر الحدودية والموانئ التي يتم تهريب المخدرات عبرها.
أثر المخدرات على الأمن المجتمعي
تشكل المخدرات تهديدًا للأمن الداخلي في العراق، وتعد من أدوات منهجية الإنفلات الأمني المعتمدة من حكومات الاحتلال المتعاقبة في البلاد، حيث يؤدي تعاطيها إلى تدهور الأوضاع الصحية والاجتماعية، فضلاً عن زيادة العنف والجريمة في المجتمع. كما أن بعض الفئات المجتمعية، وخاصة الشباب، أصبحوا عرضة للانخراط في الشبكات الإجرامية التي تدير تجارة المخدرات.
وتعد تجارة المخدرات في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة قضية معقدة وظاهرة متفاقمة في العراق، نظرًا للتداخل بين الفساد الحكومي، وضعف المؤسسات الأمنية، وحالة الفوضى السياسية. كما أن تورط الأحزاب المتنفذة أو الجهات الأمنية في التهريب يصعب على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني العراق في ظل الاحتلال المستمر من مشاكل اقتصادية واجتماعية ممنهجة تجعل من الصعب تعزيز برامج مكافحة المخدرات بشكل فعّال.
وعلى الرغم من أن الحكومة في بغداد تُعلن في العديد من المناسبات عن خطط لمكافحة المخدرات، إلا أن هناك شكوكًا حول مدى جديتها في محاربة هذه الآفة، خاصة في ظل وجود أدلة على تورط جهات متنفذة داخل الحكومة في هذه التجارة. لذا نجد تكريسا للفساد داخل المؤسسات الأمنية، وتغييب الرقابة على الحدود، وإفلات المتورطين في تجارة المخدرات من العقاب.
أدوية مغشوشة لعلاج السرطان
في حين كشفت وثائق عن وجود حالات غش وتزوير لأدوية شركات عالمية من قبل شركة تؤمّن الأدوية لمستشفيات مرضى السرطان منذ ثمان سنوات، وأنه وعلى الرغم من أن السيطرة النوعية قد طلبت إجراء تحقيق في القضية منذ العام 2020، إلا أن هذا التحقيق لم يجر حتى الآن.
أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في العراق بعد الاحتلال:
يعد الاحتلال وإفرازاته، ولاسيما الفوضى العارمة والإنفلات الأمني، المسبب الأول لجميع مشاكل القطاع الصحي في العراق ولسوء الإدارة والفساد الذي يعاني منه القطاع، حيث يُنظر إلى جميع مشاكل القطاع على أنها نتاج للتدهور الأمني والفساد المستشري في الأجهزة الحكومية بعد الاحتلال.
أولاً: التأثيرات الأمنية على القطاع الصحي وتشمل:
الاستهداف المباشر للمرافق الصحية: من أكثر المؤثرات على أداء القطاع الصحي في العراق ما بعد الغزو الأمريكي هو تكرار الهجمات على المستشفيات والمراكز الصحية من قبل قوات الاحتلال أو القوات الحكومية والميليشيات المختلفة طوال العقدين الماضيين، ما أدى إلى تدمير العديد من المنشآت الصحية. والمستشفيات في كثير من المناطق في البلاد، مثل بغداد والبصرة وديالى والأنبار ونينوى، التي عانت بشكل كبير من الدمار نتيجة الغزو والاحتلال والصراعات، ما أدى إلى تقليص الخدمات الطبية. وإن عدم توفير الحماية الكافية لهذه المنشآت يعكس جانبا من مخطط الاحتلال الرامي إلى استهداف أمن المواطنين العراقيين وتدمير المؤسسات الحيوية في البلاد.
استهداف الأطباء والعاملين في القطاع الصحي: استهداف الأطباء والكوادر الطبية أصبح جزءًا من الأزمة الأمنية في العراق منذ اليوم الأول للاحتلال، حيث تم تسجيل الآلاف من حالات اختطاف وقتل لأطباء، وخاصة في العاصمة بغداد. هذه التهديدات دفعت الكثير من الأطباء إلى مغادرة البلاد، ما أسهم في نقص الكوادر الصحية، وزيادة العبء على من تبقى. وإن الغياب المتعمد لخطة أمنية شاملة تضمن حماية العاملين في المجال الصحي يعكس جانبًا آخر من مخطط الاحتلال المتمثل باستهداف الثروات البشرية للعراق.
تقليص قدرة المستشفيات على العمل بسبب القصف واستمرار التهديدات: العمليات العسكرية المستمرة في العراق اتخذت المستشفيات هدفا لها ما جعلها غير قادرة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة بسبب تدمير البنية التحتية وصعوبة توفير الخدمات الأساسية. على سبيل المثال، تسببت الغزو والاحتلال في تقليص قدرة المستشفيات على استقبال المصابين من المدنيين أو الجنود. وإن التقاعس الواضح عن تأمين البنية التحتية الصحية يُعتبر دليلاً على الاستهداف المباشر وغير المباشر حماية المواطنين، خاصة في الأوقات الحرجة.
تدهور الثقة في النظام الصحي بسبب الفوضى الأمنية: في ظل الإنفلات الأمني وانتشار الميليشيات المسلحة في معظم المناطق، أصبح من الصعب على المواطنين الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الميليشيات تمنع أو تعرقل الوصول إلى المستشفيات أو تمنح الأولوية لجهات معينة. وقد سمحت الحكومات المتعاقبة للميليشيات في فرض سيطرتها على المشهد العراقي، ما أسهم في تقويض الثقة في النظام الصحي وفي المؤسسات الحكومية بشكل عام.
ويُعتبر تأثير الوضع الأمني على القطاع الصحي في العراق نتيجة مباشرة للفشل الحكومي في تأمين البلاد، والسيطرة على الميليشيات المسلحة، وتنظيم القطاع الصحي. الأزمة الأمنية تُعتبر جزءًا من الإخفاقات السياسية والإدارية التي أدت إلى تدهور كبير في قدرة العراق على توفير خدمات صحية كافية وآمنة لمواطنيه.
ثانيًا: الفساد الإداري والمالي:
إهدار الأموال العامة: الحكومة في العراق مستمرة بإهدار الأموال المخصصة للقطاع الصحي، سواء في شراء الأدوية أو تجهيز المستشفيات. ويتم تحويل الأموال التي يفترض أن تذهب لتوفير خدمات طبية أساسية إلى حسابات خاصة، وهو ما يعمق الأزمة الصحية في البلد.
الصفقات المشبوهة: غالبًا ما يتم تخصيص عقود لشراء الأدوية أو المعدات الطبية من خلال صفقات غير شفافة أو فاسدة، مما يؤدي إلى تأخير في وصول الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية.
الاستيلاء على الموارد: يتم سرقة أو التلاعب في الموارد التي تخصص للمستشفيات والمراكز الصحية، ما يساهم في نقص الأدوية والمستلزمات الضرورية مثل أسطوانات الأوكسجين أو الأجهزة الطبية الأساسية.
ثالثًا: نقص التمويل:
عجز الميزانية الصحية: في العديد من السنوات، كانت وزارة الصحة العراقية تواجه عجزًا في الميزانية المخصصة لها، بسبب سوء إدارة الموارد المالية، بينما تستمر الموازنة العامة في تخصيص مبالغ ضخمة للوزارات الأخرى.
الاعتماد على المعونات الدولية: بسبب ضعف التمويل المحلي، يضطر العراق إلى الاعتماد على المساعدات والمنح من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، ما يجعل القطاع الصحي غير مستقر ويعتمد على الخارج بشكل مستمر.
رابعًا: البنية التحتية السيئة:
تدهور المباني والمرافق الصحية: معظم المستشفيات والمراكز الصحية في العراق تعاني من حالة تدهور كبيرة من جراء تعرضها للتخريب والنهب والتدمير نتيجة الغزو والاحتلال وما تلاهما من حروب ونزاعات.
نقص الأجهزة الطبية الأساسية: حتى المستشفيات الكبيرة تفتقر إلى الأجهزة الأساسية مثل أجهزة الأشعة المقطعية (CT Scan)، أو أجهزة تصوير الرنين المغناطيسي (MRI)، مما يحول دون تقديم تشخيصات طبية دقيقة.
خامسًا: الإهمال المتعمد للقطاع الصحي:
الضعف الكبير في تقديم الخدمات: تعاني جميع المناطق في العراق من نقص كبير في الخدمات الصحية. وفي ظل حكومات الاحتلال يضطر المواطنون إلى السفر خارج العراق لتلقي العلاج.
النقص الكبير في المرافق الصحية: العديد من مناطق العراق لا توجد فيها مستشفيات أو مراكز صحية متكاملة، بل يتم الاكتفاء بمراكز صحية بدائية تفتقر إلى الكوادر الطبية والمعدات اللازمة.
سادسًا: ضعف تدريب الكوادر الطبية:

ندرة التدريب المستمر: بالرغم من أن العراق يمتلك نظامًا تعليميًا طبيًا معترفًا به، إلا أن الأطباء والممارسين الصحيين لا يحصلون على فرص كافية للتدريب المستمر، حيث إن النظام الطبي في العراق يعاني من نقص في الفرص لتحديث المهارات الطبية بما يتناسب مع أحدث الأساليب العلاجية.
الهجرة الجماعية للأطباء: بسبب الظروف الصعبة، اضطر معظم الأطباء إلى مغادرة العراق للبحث عن الأمن والأمان في دول أخرى مثل الأردن أو دول الخليج أو في الدول الغربية، مما تسبب في نقص حاد في الأطباء والممرضين.
إن الدمار الناتج عن الحروب والنزاعات التي مر بها العراق خلال الغزو الأمريكي للبلاد، وما أعقبه من احتلال وحروب مفتعلة تسببت في تدمير العديد من المنشآت الطبية، الأمر الذي أثر بشكل كبير على قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين.
خروج الكوادر الطبية المؤهلة: خلال الغزو الأمريكي للعراق تم تدمير العديد من المستشفيات وتم استهداف الأطباء والممرضين، ما جعل معظم المناطق تفتقر تمامًا إلى الأطباء والمعدات الطبية اللازمة. وبسبب الوضع الأمني السيء والاستهداف الممنهج، فضل معظم الأطباء مغادرة العراق. وهذا أفقد المستشفيات العراقية الكوادر المؤهلة والقادرة على تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين.
يوجد في العراق نقص حاد في العديد من التخصصات الطبية الدقيقة، مثل جراحة القلب والأورام، نتيجة لهجرة الكفاءات الطبية المتخصصة، ما أحدث فراغًا كبيرًا في هذه المجالات الحيوية.
إن استهداف الأطباء وهجرة العقول من العراق ما بعد الغزو الأمريكي يعتبران من الظواهر التي تتصدر مشاكل القطاع الصحي بعد الاحتلال، وإن استهداف الأطباء في العراق بعد 2003، سواء من خلال التهديدات الأمنية أو الهجمات الموجهة ضدهم، هو جزء من أزمة أوسع تعكس ضعفًا ممنهجًا لسيطرة الدولة على البلاد وغيابًا متعمدًا للأمن والاستقرار في جميع مناطق العراق. وتشير جميع التقارير إلى مقتل أو تهديد الآلاف من الأطباء، وأن هذا الاستهداف مرتبط بالفساد المستشري في القطاع العام، والحكومات المتعاقبة غير معنية بحماية العاملين في القطاع الطبي، وهو ما يؤكد أن القطاع الصحي في العراق الجديد، الذي يعد جزءًا حيويًا في أي دولة، يتعرض للتقويض بشكل ممنهج
أما بخصوص هجرة العقول، فهي أيضًا تُعتبر من المشاكل الكبيرة في العراق ما بعد الغزو التي تتحمّل سلطة الاحتلال وحكوماتها المتعاقبة كامل مسؤوليتها. يُعتقد أن الأطباء والمهندسين والعلماء والكفاءات العليا يغادرون البلاد بشكل متزايد بحثًا عن فرص أفضل في الخارج بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردية. وهجرة العقول هذه تؤدي إلى فقدان العراق للكفاءات التي يمكن أن تساهم في تطوير البلاد.
ولا توجد في العراق الجديد استراتيجية فعّالة للحد من هذه الهجرة، ولا تقدم الحكومات محفزات حقيقية لتشجيع الكفاءات على البقاء. كما أن الفساد المستشري المسكوت عنه يعوق أي إصلاحات حقيقية في التعليم والصحة والمجالات الأخرى، ويجعل بيئة العمل في العراق غير مشجعة للمواهب والكفاءات.
سابعًا: غياب الرقابة الفعالة:
غياب الشفافية: غياب الرقابة الفعالة على المشاريع الصحية يؤدي إلى تدهور الأداء، حيث يُستنزف المال العام من خلال صفقات فاسدة دون محاسبة أو شفافية.
عدم محاسبة المسؤولين: المسؤولون عن التدهور في القطاع الصحي لا تتم محاسبتهم، ما يجعل الفساد مستمرًا. هذا يؤدي إلى تعميق الأزمة الصحية بدلاً من حلها، لأن مَن في المناصب العليا لا يواجهون أي عواقب.
ثامنًا: التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية:
ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية: بسبب الفقر وقلة الخدمات الأساسية، يضطر المواطنون إلى اللجوء إلى القطاع الخاص، الذي لا يستطيع الكثيرون تحمل تكاليفه. وهذا يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والمرض.
الفجوة بين الفئات الاجتماعية: الطبقات الاجتماعية الضعيفة تعاني من نقص شديد في الوصول إلى الرعاية الصحية في العراق ما بعد الغزو الأمريكي، بينما تستفيد فئات قليلة من الخدمات الخاصة.
ويعاني القطاع الصحي في العراق من مشاكل متفاقمة عديدة تشمل الفساد الإداري والمالي، ونقص التمويل، وتهالك البنية التحتية، واستمرار الهجرة الجماعية للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، إضافة إلى تأثيرات النزاعات الأمنية. كل هذه المشاكل تتجذر في ضعف السياسات الحكومية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي ويجعل المواطنين يعانون في الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

وبشكل عام، تثير هذه الظواهر القلق الكبير بشأن مستقبل العراق، إذ إنها تؤثر على قوة الدولة في الحفاظ على مؤسساتها الحيوية مثل القطاع الصحي، بينما تعزز من شعور المواطنين بعدم الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق التغيير المطلوب.
الوضع البيئي
تُعتبر البيئة في العراق ما بعد الغزو الأمريكي ضحية من ضحايا الإهمال الحكومي، وفي الوقت الذي تتطلب فيه الأزمة البيئية في العراق حلولًا سريعة وفعّالة، فإن جميع الحكومات المتعاقبة قد فشلت في تقديم الحلول التي تضمن مستقبلاً بيئيًا مستدامًا للأجيال القادمة، حيث بات العراق في ظلها يواجه العديد من التحديات البيئية التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين وصحتهم. هذه التحديات تشمل التلوث الهوائي والمائي والبري، واستنزاف الموارد والثروات الطبيعية، وزيادة التصحر، بالإضافة إلى تدهور التنوع البيولوجي، وذلك نتيجة لعدة عوامل مثل الفساد، سوء الإدارة، والإنفلات الأمني، واستمرار النزاعات المسلحة. هذه المشكلات البيئية تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث يحق لكل فرد في العراق العيش في بيئة صحية وآمنة.
ويُعد الوضع البيئي في العراق من جملة القضايا التي تكشف عن فشل السياسات الحكومية في الحفاظ على البيئة واستدامتها. ويعاني العراق في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة من مشاكل بيئية خطرة تُهدد حياة المواطنين وتؤثر بشكل كبير على صحة المجتمع واقتصاده. وتعتبر السياسات الحكومية الفاشلة مسؤولة عن تفاقم هذه الأزمات بسبب الإهمال المستمر، وتقصير الدولة في وضع استراتيجيات فعّالة لحماية البيئة.

ويشمل التدهور البيئي في العراق مجموعة من الأبعاد مثل: التصحر، وتلوث المياه، والتلوث الهوائي، الذي نتج بشكل أساسي عن الاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية، وعدم وجود رقابة فعّالة على الصناعة والزراعة. كما يساهم الاحتلال والحروب والنزاعات السياسية المستمرة في زيادة هذه المعضلات البيئية، وأسفرت عن تدمير الكثير من البنية التحتية البيئية.
بالمقابل، لم تبذل الحكومات المتعاقبة جهودا كافية للتعامل مع هذه التحديات، بل كانت سياساتها في كثير من الأحيان، مثل سوء إدارة الموارد المائية، تزيد من تعقيد الأزمة البيئية. في هذا السياق، يعد الفساد المستشري في القطاع الحكومي سببا رئيسا في غياب الحلول الجذرية لهذه المشكلات، مما جعل العراق يعاني من أزمة بيئية تتفاقم عامًا بعد عام.
الثروة المائية بين الاعتداءات المستمرة والإهمال الحكومي
إن استمرار انتهاك ثروة العراق المائية والاعتداءات المتكررة على حصة العراق المائية من قبل دول الجوار، والإهمال الحكومي في معالجة الأنهر، وتدني الوعي الشعبي، وانعدام الرقابة وانتشار عمليات إلقاء المخلفات في الأنهر يساهم في ترسيب أزمة المياه المتفاقمة في البلاد، التي تعاني من أزمة حادة في توفير مياه الشرب الصالحة، حيث تشير التقارير إلى أن حوالي نصف السكان فقط يحصلون على مياه نظيفة وآمنة للاستهلاك، وسط فشل حكومي مزمن في معالجة الأسباب. إلى جانب نفوق مئات الأطنان من الأسماك، وعشرات الأنواع باتت مهددة بالانقراض، وتتفاقم هذه المشكلة بسبب تلوث الأنهار الناجم عن تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية، مما يجعل المياه غير صالحة للاستخدام البشري،
بالإضافة إلى ذلك، يعاني العراق من شح في الموارد المائية نتيجة الجفاف والتغير المناخي، مما زاد من صعوبة توفير مياه الشرب للمواطنين. وأدى إلى فقدان 50٪ من الأراضي الزراعية خلال السنوات الخمس الأخيرة. في ظل زيادة مطردة في أعداد العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لوزارة التخطيط، تبلغ نسبة الفقر في العراق حاليًا 18%، مما يعني أن نحو 9 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر في بلد يبلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة، ويمتلك من الثروات الهائلة والمختلفة ما يجعله من بين أغنى البلدان في العالم.

انخفاض الموارد المائية يدلل على غياب السيادة
يشهد العراق في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة انخفاضًا كبيرًا في موارده المائية، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية ولاسيما على النمو والتوظيف. ويوفر الاستثمار المناسب في إدارة المياه فرصة حقيقية لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في العراق، ويمثل ملف المياه قضية رئيسية في هذا البلد الذي بلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة والغني بالموارد النفطية لكنه يواجه أزمة كهرباء حادة تفاقمت كثيرا بسبب الاعتداءات على حصصه المائية المتكررة بشكل متزايد بالتزامن مع انخفاض معدلات هطول الأمطار. ولا توجد إجراءات حكومية ملموسة لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة في البلاد، وهذا سيؤدي إلى خسائر كبيرة عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد، وستؤثر على المزيد والمزيد من الفئات الأكثر احتياجا من العراقيين، الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 23 مليون نسمة.

وحذّر تقرير أصدره البنك الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، من أنه في ظل هذه الظروف، سيخسر العراق نصف أراضيه الزراعية بحلول العام 2050. وتؤدي أزمة المياه إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 5% سنويًا، أي ما يعادل 8 مليارات دولار، وكذلك تؤدي إلى انخفاض الطلب على العمالة غير الماهرة في الزراعة بنسبة 12% مقابل نسبة 5,4% من الطلب على الأنشطة غير الزراعية، وفق التقرير الذي أكد أن ندرة المياه بدأت تتسبب في تهجير قسري محدود للسكان خصوصا في مناطق جنوبي البلاد.
السياق البيئي في العراق
العراق بلد ذو تضاريس متنوعة ومناخ قاري قاسي، ويعاني من تحديات بيئية جمة. وموقعه الجغرافي الذي يمر عبره نهرا دجلة والفرات يعتبر مصدرًا هامًا للمياه في البلاد، لكنه يعاني من تأثيرات سلبية نتيجة للسياسات الحكومية الفاشلة والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، فضلا عن الضغوط الناتجة عن التغيرات المناخية.
ويمتد العراق عبر مساحة قدرها حوالي 438,317 كيلومتر مربع، مما يجعله يحتل المركز 58 في ترتيب الدول من حيث المساحة. والعراق موطن لأهم الأنهار في المنطقة، وهما نهر دجلة ونهر الفرات، اللذان ينبعان من تركيا ويمران عبر العراق قبل أن يصبا في الخليج العربي. هذان النهران يشكلان مصدرًا رئيسيًا للمياه في العراق ويمثلان شريان الحياة للسكان وللكثير من الأنشطة الاقتصادية.
وتمثل السهول الواسعة أكبر جزء من أراضي العراق، وتغطي مناطق مثل السهول الفيضية لنهر دجلة والفرات. وتوجد الجبال في شمال العراق، وخاصة في مناطق كردستان، مثل جبال زاغروس. وتقع الصحراء في الجنوب الغربي من البلاد، وتشمل مناطق مثل صحراء الأنبار. وما تبقى من العراق هي مناطق حضرية والعاصمة بغداد التي تقع على ضفاف نهر دجلة في مقدمتها. تليها مدن رئيسية أخرى مثل البصرة والموصل.
ويتميز العراق بمناخ قاري حار وجاف، حيث يكون الصيف طويلًا وحارًا، بينما الشتاء قصير ومعتدل. وعلى الرغم من التنوع الجغرافي في العراق، إلا أن هناك بعض الخصائص المشتركة للمناخ، حيث يكون الشتاء في معظم مناطق العراق باردًا نسبيًا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وتكون هناك بعض التساقطات الثلجية. في بقية المناطق، يكون الشتاء معتدلًا مع بعض الأمطار الخفيفة.
أما الصيف في العراق فيكون قاسيًا جدًا، حيث تتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق 49 درجة مئوية في معظم الأحيان، وتصل إلى مستويات عالية جدًا في جنوب البلاد، بينما المناطق الجبلية في الشمال أكثر برودة.
ويعاني العراق من شح في الأمطار، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى. وتتركز الأمطار بشكل أكبر في المناطق الشمالية من البلاد، حيث تنمو الغابات وتعد مصدرًا رئيسيًا للمياه العذبة.
أبرز التحديات البيئية في العراق
يعاني العراق من تحديات بيئية بسبب موقعه الجغرافي ومناخه، من أبرزها:
التصحر: ينتشر في المناطق الجنوبية والغربية، ويهدد الأراضي الزراعية.
التلوث: تلوث الهواء والمياه من أهم القضايا البيئية التي تهدد صحة السكان.
التغيرات المناخية وندرة الأمطار: تؤثر على قطاع الزراعة والشرب.
تراجع التنوع البيولوجي من جراء الإهمال الحكومي وغياب التشريعات البيئية.
الانتهاكات البيئية وحقوق الإنسان في العراق
1- الحق في المياه: أزمة المياه في العراق، وتلوث الأنهار، وتأثير نقص المياه وعدم إمكانية الوصول إلى مياه صالحة للشرب.
2 – الحق في بيئة صحية: النفايات الناتجة عن الغزو والاحتلال والعمليات العسكرية ولاسيما النفايات التي تحتوي على مواد سامة مثل اليورانيوم المنضب، وتلوث الهواء، والنفايات الصناعية والزراعية والطبية، وتأثيرها على الصحة العامة.
3 – الحق في الغذاء: تأثير التدهور البيئي على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
4 – الحق في التنمية المستدامة: كيفية تأثير الانتهاكات البيئية على قدرة العراق على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
5 – الحق في التعويض: حقوق المواطنين المتضررين من الأزمات البيئية، مثل التلوث والإضرار بالموارد الطبيعية.
الأسباب الجذرية للمشاكل البيئية
1- الغزو والاحتلال: حيث تسبب الغزو بدمار كبير ناتج عن الهجمات العسكرية والانفجارات، وتلوث الأراضي والمياه. وتشكل نفايات جيش الاحتلال الأمريكي في العراق موضوعًا حساسًا يتداخل مع قضايا البيئة والصحة العامة، ما يثير المخاوف بشأن تأثيرها طويل الأمد على البيئة المحلية وعلى صحة السكان.
2- الفساد الحكومي: يُعد الفساد الحكومي أحد العوامل الرئيسية التي تقف في طريق معالجة القضايا البيئية في العراق، وهو يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على حماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية. في العراق، يعاني النظام الحكومي من فساد واسع النطاق في جميع القطاعات، مما يعوق التقدم في حل القضايا البيئية الخطرة التي تهدد البلاد.
3 – سوء إدارة الموارد: استغلال غير مستدام للموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة. حيث يعاني العراق في ظل حكومات الاحتلال من سوء إدارة الموارد بسبب عوامل متعددة مثل الفساد، وضعف المؤسسات الحكومية، وتحديات الأمن والاستقرار، مما يؤثر بشكل كبير على معالجة القضايا البيئية في البلاد.
4- التغير المناخي: للتغير المناخي دور في تفاقم الوضع البيئي فيا العراق، مثل زيادة التصحر وارتفاع درجات الحرارة وقلة نسبة هطول الأمطار.
السياسات الحكومية والإجراءات القانونية
الإطار القانوني: تعتبر حقوق البيئة جزءًا مهمًا من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث تشمل الحق في بيئة صحية ومستدامة. في العراق، ورغم التحديات الكبيرة في مجال حماية البيئة، إلا أن هناك مجموعة من القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الحقوق البيئية، على الرغم من أن تنفيذها يصطدم بمشاكل أخرى مثل الفساد الحكومي المستشري وسوء الإدارة، سنقدم استعراضا موجزا للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق البيئية في العراق
القوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق البيئية:
– قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009: ويهدف إلى الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتدهور والحفاظ على التنوع البيولوجي.

– قانون الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008: ويهدف إلى إدارة الموارد المائية في العراق، بما في ذلك حماية الأنهار والبحيرات من التلوث والإفراط في الاستخدام للحفاظ على هذه الموارد للأجيال المستقبلية.
– قانون حماية وحفظ الأنواع البرية: ويعنى بحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي في العراق، ويشمل محميات طبيعية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وهو جزء من الجهود للحفاظ على النظام البيئي.
– قانون النفط والغاز: رغم أنه في المقام الأول يتعلق بإدارة النفط والغاز، إلا أنه يشمل بعض الإرشادات بشأن حماية البيئة أثناء عمليات التنقيب والإنتاج، للحد من التلوث النفطي في المياه والتربة.
2- الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق البيئية التي انضم العراق إليها:
– اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC): وتهدف إلى مكافحة التغير المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. كجزء من هذه الاتفاقية، وقع العراق على اتفاق باريس في 2015، الذي يتضمن التزام الدول الأعضاء بتقليل الانبعاثات والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
– اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) والعراق عضو فيها وتهدف إلى استخدام الموارد البيئية بشكل مستدام. من خلال هذه الاتفاقية، يلتزم العراق بحماية المناطق المحمية مثل: الأهوار التي تشهد تهديدات كبيرة بسبب التلوث والتجفيف.
– اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) والعراق من الدول الموقعة عليها وتهدف إلى إدارة الأراضي الجافة واستعادة الأراضي المتدهورة وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات التي تعيش في هذه المناطق.
– اتفاقية أوهايو بشأن حماية المياه العابرة للحدود: وقع العراق هذه الاتفاقية بهدف تنظيم إدارة الموارد المائية المشتركة عبر الحدود مع الدول المجاورة، وتطوير آليات لتجنب النزاعات المائية وضمان الاستخدام المستدام للمياه.
– اتفاقية ستوكهولم للمواد السامة والمضرة بالصحة: وتهدف إلى الحد من التلوث الكيميائي الذي يؤثر على البيئة والصحة العامة. وقع العراق على هذه الاتفاقية ضمن الجهود الدولية للقضاء على المواد السامة.
– اتفاقية رامسار حول الأراضي الرطبة: والعراق من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية التي تهدف إلى حماية الأراضي الرطبة مثل الأهوار العراقية، وهي مناطق حيوية تستضيف أنواعًا عديدة من النباتات والحيوانات المهددة.
لماذا لا يتم تنفيذ القوانين والاتفاقيات في العراق؟
رغم وجود هذه القوانين والاتفاقيات، إلا أن تنفيذها يواجه العديد من التحديات في العراق، منها:
1- غياب الاستقرار السياسي والأمني: في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق؛ تساهم الظروف الأمنية السيئة والتقلبات السياسية المستمرة في ضعف تنفيذ السياسات البيئية، وسط غياب الرقابة المزمن وضعف التنسيق الممنهج بين المؤسسات المعنية.
2- الفساد الحكومي الواسع: يعوق تطبيق القوانين البيئية ويُضعف فعالية المؤسسات المعنية بحماية البيئة.
3- التمويل المحدود: العديد من المشاريع البيئية بحاجة إلى التمويل لمواجهة تحديات مثل التصحر والتلوث، لكن غالبًا ما يفتقر العراق الجديد إلى الموارد المالية المناسبة.
4- نقص الوعي البيئي: من آثار سياسة التجهيل التي تبناها الاحتلال وحكوماته المتعاقبة؛ باتت نسبة الأمية في العراق 50% من السكان، وأصبح الكثير من المواطنين والسلطات المحلية يفتقرون إلى الوعي الكافي بأهمية الحفاظ على البيئة.
وعلى الرغم من انضمام العراق إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة وتعزيز الحقوق البيئية، إلا أن الواقع البيئي في العراق يشهد تدهورًا مستمرًا بسبب عدة عوامل تتعلق بإدارة هذا الملف في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة. هذه الحكومات، التي تدير شؤون البلاد منذ 2003، أظهرت فشلًا ذريعًا في تطبيق السياسات البيئية وحماية الحقوق البيئية للشعب العراقي، وأصبح من الواضح أن البيئة العراقية لا تحظى بالأولوية التي تستحقها. وإن الفساد الحكومي، والانفلات الأمني، وسوء إدارة الموارد جعل من العراق من أكثر الدول التي تعاني من تدهور بيئي شديد. لذا، هناك حاجة ملحة لتغيير جذري في السياسات البيئية، وأيضًا لإيجاد تعاون دولي فعّال لمساعدة العراق في مواجهة هذه التحديات البيئية الكبرى التي تهدد مستقبل البلاد. وإن معالجة القضايا البيئية في العراق ليست رفاهية أو خيارًا سياسيًا، بل ضرورة من أجل ضمان حقوق الإنسان الأساسية.